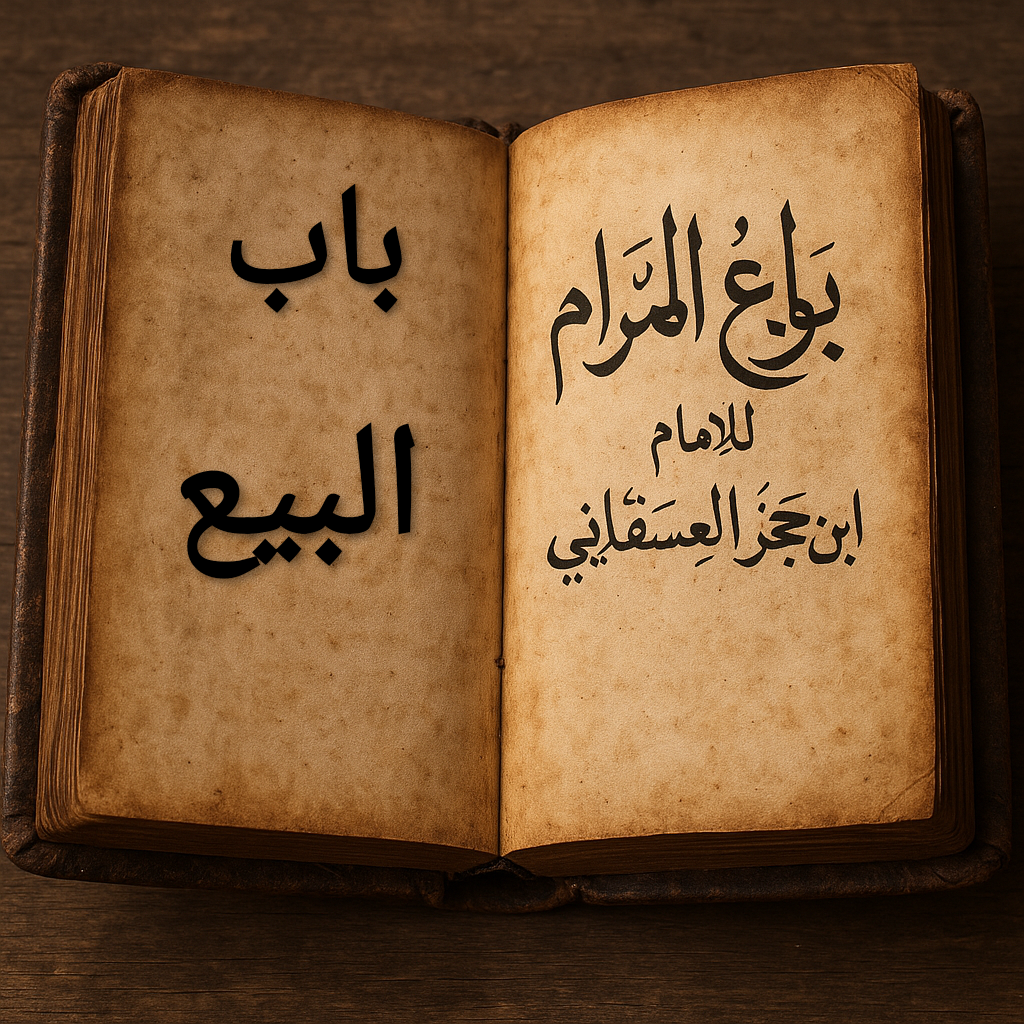بلوغ المرام لأحكام النكاح والطلاق | الدليل الشرعي الكامل
الموسوعة الشاملة لأحكام النكاح والطلاق من كتاب بلوغ المرام
المقدمة التأسيسية يُعتبر كتاب "بلوغ المرام" للإمام ابن حجر العسقلاني من أهم المراجع الفقهية التي جمعت أدلة الأحكام من القرآن والسنة النبوية الصحيحة. وسنقدم هنا شرحاً موسعاً ومفصلاً لأحكام النكاح والطلاق مع الاستقصاء الكامل للأدلة والخلافات الفقهية.
باب احكام النكاح والطلاق
الفصل الأول: حقيقة النكاح وأحكامه التكليفية
1. التعريفات
لغويًا: مشتق من النكاح بمعنى الضم والتداخل
اصطلاحًا: عقد شرعي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر
2. الأحكام التكليفية
الوجوب:
- على من خشي الوقوع في الزنا مع القدرة على النفقة
- الدليل: قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} [النور: 33]
الاستحباب:
- لمن تاقت نفسه للنكاح مع القدرة عليه
- الدليل: حديث "يا معشر الشباب..." [متفق عليه]
الكراهة:
- لمن لا يقدر على النفقة أو يخاف الجور
- الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله في النساء" [مسلم]
الحرمة:
- إذا قصد به الإضرار أو التحليل
- الدليل: حديث "لعن الله المحلل والمحلل له" [أبو داود]
الفصل الثاني: أركان النكاح وشروطه
1. الأركان الأربعة
الصيغة:
- الإيجاب من الولي: "زوجتك ابنتي"
- القبول من الزوج: "قبلت"
- الدليل: حديث "لا نكاح إلا بولي" [أبو داود]
الزوجان:
- شروط خاصة بالزوج (الإسلام، الذكورة، عدم التحريم)
- شروط خاصة بالزوجة (عدم التحريم، عدم الاعتداد)
الولي:
- ترتيب الأولياء: الأب، الجد، الأخ، العم
- الدليل: حديث "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" [أبو داود]
الشهود:
- رجلان عدلان مسلمان
- الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [البيهقي]
2. الشروط التفصيلية
- الرضا: يشترط رضا الزوجين إلا الصغيرة يزوجها أبوها
- المهر: يجب تسميته ولو رمزياً
- الخلو من الموانع: كالمحارم والعدة
الفصل الثالث: المحرمات في النكاح
1. المحرمات بالنسب
1. الأمهات والجدات
2. البنات وبنات الأولاد
3. الأخوات
4. العمات والخالات
- الدليل: قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ...} [النساء: 23]
2. المحرمات بالرضاع
- ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع
- الدليل: حديث "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [متفق عليه]
3. المحرمات بالمصاهرة
1. زوجات الآباء
2. زوجات الأبناء
3. أم الزوجة
4. بنات الزوجة المدخول بها
الفصل الرابع: حقوق الزوجين
1. حقوق الزوجة
النفقة:
- الطعام والكسوة والسكن
- الدليل: قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} [البقرة: 233]
المعاشرة بالمعروف:
- الدليل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]
المهر:
- الدليل: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]
2. حقوق الزوج
الطاعة في غير معصية:
- الدليل: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34]
حق القسمة:
- العدل بين الزوجات
- الدليل: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: 3]
الباب الثاني: الطلاق
الفصل الأول: حقيقة الطلاق وأحكامه
1. التعريفات
لغويًا: التحرر من القيد
اصطلاحًا: حل عقد النكاح
2. الأحكام التكليفية
الجواز:
- عند الحاجة
- الدليل: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]
الكراهة:
- بلا سبب
- الدليل: حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" [أبو داود]
الحرمة:
- الطلاق البدعي
- الدليل: حديث ابن عمر في طلاق زوجته حائضاً [متفق عليه]
الفصل الثاني: أنواع الطلاق
1. الطلاق السني
- يكون بطلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه
- الدليل: حديث ابن عمر [البخاري]
2. الطلاق البدعي
1. في الحيض
2. في طهر جامعها فيه
- الدليل: قول عمر: "أما أنا فأنكره وأحسبه وأحاكمه" [مالك في الموطأ]
3. الطلاق الرجعي
- يمكن الرجوع فيه أثناء العدة
- الدليل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]
4. الطلاق البائن
1. البائن بينونة صغرى
2. البائن بينونة كبرى
- الدليل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: 230]
الفصل الثالث: شروط الطلاق
1. شروط المطلق
1. البلوغ
2. العقل
3. الاختيار
4. النية (في الكناية)
2. شروط المطلقة
1. أن تكون زوجة صحيح النكاح
2. عدم الاعتداد من طلاق سابق
3. عدم كونها حاملاً في طلاق بدعي
الفصل الرابع: العدة والرجعة
1. أحكام العدة
الحرة غير الحامل: ثلاث حيضات
- الدليل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]
الحامل: حتى الوضع
- الدليل: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]
الصغيرة والآيسة: ثلاثة أشهر
- الدليل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: 4]
2. أحكام الرجعة
طريقة الرجعة:
- بالقول: "راجعتك"
- بالفعل: بالوطء بشهوة
- الدليل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]
شروطها:
- أن يكون الطلاق رجعياً
- أن تكون في العدة
- أن تشهد عليها
الفصل الخامس: الطلاق الثلاث والخُلع
1. الطلاق الثلاث
حكمه:
- يقع ثلاثاً عند الجمهور
- الدليل: حديث ركانة [أبو داود]
آثاره:
- تحرم حتى تنكح زوجاً غيره
- الدليل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ} [البقرة: 230]
2. الخُلع
تعريفه:
- فسخ النكاح بطلب الزوجة مع التنازل عن بعض حقوقها
- الدليل: قصة ثابت بن قيس [البخاري]
أحكامه:
- لا رجعة فيه
- يقع بلفظ الخلع أو الفدية
- الدليل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229]
الخاتمة العامة
هذه الموسوعة الشاملة قد استوعبت - بحمد الله - أهم أحكام النكاح والطلاق كما وردت في كتاب "بلوغ المرام"، مع ذكر الأدلة التفصيلية من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، وبيان الخلافات الفقهية في المسائل المختلفة.
وختاماً فإن هذه الأحكام الشرعية تحتاج إلى فهم دقيق وتطبيق حكيم، خاصة في مسائل الطلاق التي قد تكون لها آثار اجتماعية ونفسية بالغة. والله تعالى أعلم وأحكم.
كتاب " بلوغ المرام" - الحافظ العلامه إبن حجر العسقلاني
✍️ بقلم: سامح محمد ناصر العولقي
كل الحقوق محفوظه لموقع مدونة سامح العولقي بالإشتراك مع مدونة قناتك2